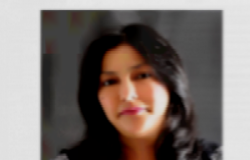في رحلتي منذ أيام قليلة مضت لمحافظة أسوان الساحرة، بدعوة كريمة من صديقي وزميلي الصحفي الكبير الأستاذ. على القماش، استحضرت من الذاكرة زيارتي لمملكة السويد الرائعة منذ 35 عامًا، ووجدت نفسي استرجع في يسر، بعض تفاصيل الحوار الذي دار بيني وبين مواطن سويدي يعشق حضارتنا القديمة إلى حد الوله، كما يعشق جمال مصرنا الحديثة بجوها المعتدل وشعبها المضياف.
وفي رحلة إلى أسوان بنيلها الخالد، سعدت بمشاركة عدد لا بأس به من السادة الزملاء الصحفيين ( نساءا ورجالا )، تجمعنا أمام محطة قطارات مصر بميدان رمسيس في تمام الساعة العاشرة مساء، لنستقل قطار الحادية عشر ليلا، داخل القطار – بصرف النظر عن ضعف امكاناته وندرة خدماته – سعدنا جميعنا بالأحاديث الثنائية، والجماعية التي كانت "الزاد والزواد" الممتع لكسر حدة الوقت الذي امتد إلى نحو 15 ساعة تقريبا، ومن حسن حظى أن جاء مقعدى بجوار مقعد صديقي وزميلي الخلوق، الأستاذ محمود النوبي ( مدير تحرير الأهرام ).
وصلنا إلى محطة أسوان بسلامة الله، ومنها إلى أحد الفنادق المطلة على ضفاف النيل، وبدأت رحلتنا الجميلة مع صحبة أكثر جمالا، وأصحاب مكان (أهل أسوان) من أرقى وأروع ما يمكن، ولأن الأماكن التي زرناها كثيرة ومتفردة في الجمال والسحر، فسأكتفي في هذا المقال بالكتابة عن معبد فيلة، على أن أتناول تفاصيل بقية الأماكن الأثرية التي زرناها بهذه الرحلة الممتعة في مقالات قادمة.
وكانت البداية من مستوى قارب صغير يضمني وزملائي الكِرام، بدت جزيرة فيلة بأشجارها، وأعمدتها، وهوائها وسمائها، وكأنها الماضي المصري العريق بكل: جبروته، علمه، تاريخه، وحضارته المتفردة، والمتسيدة على العالم أجمع، فالصخور الضخمة رائعة المنظر مكدسة حول الجزيرة، تحيطها المياه، أو هي تحيط المياه من كل الجوانب، وكأنها الحارس الأمين لهذا الماضي العريق، وعلى بعد أمتار من البحر، نرى الجبل الأرجواني الراقد بالقرب منا، وفوق هذا الجبل، تظهر الطيور في انسيابية وجمال لا مثيل لهما، ومع انزلاق القارب بجانب الصخور اللامعة، ترتفع الأبراج المنحوتة إلى أعالي السماء، تبدو جميعها صلبة، فخمة، وكاملة؛ لدرجة تجعل المرء منا ينسى أي شيء دونها في تلك اللحظة...!!
لا تندهش عزيزي القارئ حين ترى أو لنقل (تتخيل) موكب الكهنة ذوي الملابس البيضاء، وهم يحملون سفينة التابوت؛ يصحبهم صوت الهتاف العتيق محمولاً عبر النسيم بهدوء، بينما هم قادمون من جولتهم الواسعة بين النخيل والأعمدة ، تلك هي الكلمات التي وصفت بها كاتبة السفر البريطانية الشهيرة "أميليا إدواردز" تجربتها حين زارت معبد فيلة لأول مرة في عام 1873.
كان معبد فيلة - شأنه كشأن الأهرامات الثلاثة في تحديها للزمن وشموخ من أقامها - بقعة سياحية شهيرة يزورها الناس من مختلف بقاع الأرض في القرني: الثامن والتاسع عشر، وهؤلاء هم من حالفهم الحظ برؤية الجدران والأعمدة بألوانها الزاهية على هيئة نشأتها الأولى قديماً، لكن بعد بناء السد العالي الذي كان ولابد من بنائه حفاظا أمننا المائي والغذائي، غمرت المياة جزيرة فيلة بأكملها لتختفي تحتها ألوان المعبد الزاهية إلى الأبد....!!
ولحسن الحظ، أنقذ المشروع المشترك بين "اليونسكو وحكومتنا"، معبد فيلة من أعماق النيل، وقد نُفذ المشروع خلال عشرة سنوات من عام 1970 حتى 1980، حيث قام المهندسون أولاً ببناء سد كبير حول جزيرة فيلة، ثم أزالوا المياه بمضخات قوية، وبعد مجهودات مضنية، تم فصل معبد فيلة الذي وُصف بأنه عبارة عن 40،000 قطعة فريدة عن الجزيرة، ثم نقل المعبد بأكمله - قطعة قطعة - إلى أرض أعلى في جزيرة أخرى، ثم تعاونوا فيما بعد على رصه كقطع الأحجية ليظهر في هيئته الحقيقية قبل الغرق، ولازالت الجزيرة التي حملت معبد فيلة قديماً في أعماق بحيرة ناصر، وعلى الرغم من أن السائحين اليوم لا يمكنهم رؤية جمال فيلة الأصلي، إلا أن المعبد نفسه لازال صامداً بحالة مذهلة تمكننا من رؤية لمَ كان هذا المعبد مهمًا بالنسبة للمصريين القدماء.
ولأن الشئ بالشئ يذكر، يرجع مسمي معبد فيلة للإسم "فيلة" أو "فيلاي" الذي يُعني (الحبيبة) أو (الحبيبات) في اللغة الإغريقية، تقع الجزيرة في أقصى جنوب مصر كآخر مركز للديانة المصرية القديمة منذ 4000 عام...!!.. وكانت تلك البقعة عبارة عن جزيرة مقدسة، ومركزًا مهمًا ومكرسا لعبادة إيزيس التي تعد وزوجها أوزوريس وابنهما حورس، أهم ثلاث شخصيات في الأساطير المصرية القديمة، حيث تشابهت قصتهم مع واحدة من أكثر كتابات شكسبير مأساوية، "مثلت إيزيس" إحدى أهم الشخصيات في العالم القديم، عُرفت كمعالجة، واهبة للحياة، وحاميةً للملوك...!!. لم تشتهر أسطورتها فقط في زمن المصريين القدماء، لكنها انتشرت في جميع أنحاء اليونان والإمبراطورية الرومانية؛ بل وشُيد لها لاحقاً معبداً خاصاً في لندن.....!!
تحكي هذه الأسطورة عن جدال صغير بين "أوزوريس" وشقيقه "ست" أدي إلى معركة كبيرة بين الأخوين، تمكن فيها "ست" من قتل "أوزوريس"، وتقطيع جثته إلى عدة قطع تناثرت حول مصر، فتشت إيزيس (الزوجة المتفانية) في كل بقاع مصر حتى عثرت على جميع قطع جسم زوجها، وبفضل قوتها السحرية، نجحت في إعادة أوزوريس إلى الحياة لفترة وجيزة ولدت خلالها إبنهما حورس! نشأ حورس في أحراش الدلتا وحين أصبح رجلاً، انتقم لوالده وقتل عمه ست. وفقًا للأسطورة، فإن جزيرة فيلة هي المكان الذي وجدت فيه إيزيس قلب أوزوريس، قبل أن تقوم بدفنه في جزيرة قريبة.
نأتي بعد ذلك للحظة عرض الصوت والضوء الرائع الذي يُقام عند معبد فيلة، بما يعني إعادة الحياة إلى الآلهة المصرية أمام أعين الجمهور لإخبارهم قصص حياتهم، وذلك من خلال الأضواء المبهرة والاستماع إلى الموسيقى بأصوات رصينة ومبهرة من أعمق قيعان التاريخ القديم، هذا العرض يجلب التاريخ والماضي معا للحياة، حيث يقدّم أسطورة أوزوريس (إله الموت) وزوجته المحبوبة إيزيس التي أعادت إحياء زوجها باستخدام طقوس الحياة بعد أن قتلت شقيقه ( إله الشر في مصر القديمة ).
بعد هذا العرض الساحر للصوت والضوء، مهم جدا معرفة القارئ العزيز بأن المصريين القدماء، أول من اعتقد بنعم الآلهة فى مواسم الحصاد: (نبرى) إله الحصاد.. و ( سخت ) ربة الحقول..و ( أوزيريس ) إله الزراعة.. وزوجته ( إيزيس ) رمز الوفاء والفلاحة المصرية.. و( رننوت ) تحمى الحقول وتقتل الفئران، فالحضارة الفرعونية القديمة زاخرة بالجمال واحترام المواسم وفصول السنة المختلفة، ومع اقتراب نهاية موسم حصاد القمح وقصب السكر بجنوب الصعيد، نرصد فيما يلى تاريخ القدماء المصريين مع آلهة الزراعة والحصاد، واحترامهم الكبير لنهر النيل.
في هذا السياق، يحضرني أيضا خبر تقديم مصر إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية الحبوب تابعة للأمم المتحدة، والتي جرى إبرامها قبل عقود، وفي سياق الخبر : " يأتي انسحاب مصر من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي على خلفية السياسة المالية غير المسؤولة لدول الغرب، ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995، وتقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 يونيو من العام الجاري">
لذا، لا يعقل أن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام المؤامرة الأمريكية – الغربية علي شعبها انتظارا لاستيراد القمح المقرون بتوفير العملة الصعبة لأسباب يطول شرحها، في الوقت الذي تمد روسيا يدها إلينا وتعطينا ما نحتاجه من القمح مقابل عملتها أو عملتنا.....!!.. إذا هذه الخطوة موفقة جدا، بل ومهمة في هذا التوقيت الفارق من تاريخ البشرية عامة، ومصر خاصة، لأنها وبكل بساطة، أضافت لمصر ميزة التحرك في استيراد ما تريده ممن تريده بعيدا عن "الدولار الأمريكي" الذي تسبب لنا في كوارث إنسانية حالية ومستقبلية أثرت بشكل مباشر على أغلب طبقات الشعب.
وهنا لابد وأن نرجع إلى تاريخنا القديم، لنأخذ منه العبرة والعظة، خصوصا في مجالي: المياه والزراعة، وهذا ما فظن إليه ووعاه جيدا أجدادنا قدماء المصريين، فهم أصاحب الاعتقاد بأن الخيرات التى تأتى بها الأرض ماهى إلا نعمة من نعم الآلهة، وأهم هذه الآلهة فى التاريخ الفرعونى هم: الإلة "نبرى"، والذى يظهر على منقوشات الجدران الفرعونية بشكل رجل ممتلئ وصدره متتدلى لأسفل، مرسوم على جسده حبوب الغلال، كما جاء تمثيل هذا الشكل لـ "نبرى" ليؤدى السوع، حيث تم تجسيد ربة الحقول المعروفة باسم "سخت" تحمل تلك الربة رمزها على رأسها، وتمسك مائدة قرابين تحتوى على: بيض، بطتين صغيرتين، سمك، وأوز ويسير أمامها "نبرى" الذى يمكن رؤية اسمه بوضوح ممسكا بحزمتى حنطة فى شكل قمع أو مخروط مقلوب مشكل قمته بجزوع السنابل، ويمكن القول بأن ظهور نبرى بهذا الشكل يعبر عن كونه إله للحصاد.
كما حرص أجدادنا القدماء على تجسيد "أوزوريس" إلها للزراعة والحقول الخضراء، كما جسدوه أيضا فى طبيعته "الحياة الخالدة الآبدية"، حيث إن "أوزوريس" كان لدي قدماء المصريين عبارة عن رئيس محكمة الإلهة فى العالم الآخر، وكتجسيد للموت والبعث، فكان يروق للمصرى القديم أنه سيبعث بعد موته، لدرجة أنه لا يخاطب باسمه إلا مقترن باسم أوزوريس بفضل هذا التوحيد، وكان المصرى القديم على يقين من أن خلوده هذا فيه توحد لم يكن ليتم بمجرد الإيمان بالعقيدة الأوزورية وأداء شعائرها وطقوسها وبالاشتراك فى الاحتفالات المهيبة فى أبيدوس، وإنما كان لابد له (المصري القديم) أن يمارس حياة خلقية راقية تماثل النموذج الذى قدمه هذا الإله فى حياته طبقا للأسطورة الذى علم الناس الزراعة والعلوم والفنون، وموت "أوزوريس" وبعثه، ما هو إلا انعكاس لموت الأرض والزرع أثناء الجفاف وبعث الخصوبة والحياة بعد الفيضان.
أما عن "إيزيس" زوجة "أوزوريس"، فهى التى ترمز لـ "الفلاحة فى التاريخ المصرى القديم"، والمنطقة التى يسير فيها موكب إله الخصوبة خلال الاحتفال، الخروج يعبر رمزيا عن أم الإله مين وهى الإلهة إيزيس التى يقوم الإله مين باحتضانها خلال موكب، وفى نفس الوقت كانت هذه المرحلة وما يقوم به إله الخصوبة خلالها لتحويل مرحلة الموت من خلال الإخصاب إلى مرحلة الميلاد، وتحاكى فى مضمونها الدور الذى يؤديه النيل فى فصل الفيضان لتحويل أرض مصر من مرحلة الجدب (فصل الجفاف) إلى مرحله الميلاد (فصل النيات).
كما أنه وجد خلال العصور الفرعونية الآلهة "سخمت" الهة الحقول، وقد مثلت فى هيئة امرأة توجت بنبات دال على اسمها (سخت) وتعنى حقل، وهى تحمل مائدة قرابين بها طيور وبيض وأسماك وفى يديها أوراق وزهور اللوتس، ومن الصور تلك الموجودة فى معبد أمنحتب الثالث من عصر الأسرة الثامنة عشر بوادى السوع شمال قرية السوع بالنوبة.
وبخصوص الالهة "سيشات"، فقد كانت آلهة الكتابة وكان من وظائفها تسجيل سنين حكم الملك وأعماله على الشجرة المقدسة فى هيليوبليس، وكانت تساعد الملك فى تحديد مساحات المعابد عند إنشائها وفى قياس الأراضى، وصورت على هيئة امرأة وعلى رأسها عود أو ساق ينبثق أو يتفرع منه سبعة وريقات يعلوه قرنان فى وضع مقلوب، والآلهة "حتحور"، وهى آلهة السماء وكانت توصف بأنها ابنة رع وزوجة حورس، وهى تصور على هيئة بقرة حيوانها المقدس أوفى صورة آلهة برأس بقرة وعادة إمرأة برأس بشرى يزودان بقرنى بقرة أو فقط بأذنيها وضفائر سمكية تحيط بالوجه.
وعن الالهة "رننوت" فكانت تظهر إما فى شكل أفعى فى وضع تحفظ الهجوم والقضاء على الأعداء، حيث إنها تأكل الفئران التى تهدد المحاصيل، أو فى شكل امرأة لها رأس أفعى جالسة ترضع ابنها المعبود (نبرى) إله الحبوب، وصفات الإلهة "رننوت" عديدة ولكنها متصلة بفكرة الحبوب والحصاد والطعام والتغذية نتيجة لكونها إلهة الحماية فالبتالى ستوفر الحماية للمحصول الذى سيحصد ومن خلال كونها آلهة ولادة فهى تضمن الإخصاب المستمر للتربة.. وللحديث بقية.




 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي