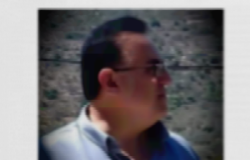ولأنني – كغيري – من القلقين على مستقبل وطننا الكبير لزيادة وسرعة وتيرة المؤامرات وتعدد أشكال المتآمرين: العالميين، الإقليميين والمحليين وألاعيبهم مؤخرًا، فدائما وأبدًا أرصد بعيني، وأسجل بعقلي كل وأي حدث – خيرًا أو شرًا - ذات صلة بمصرنا الحبيبة خاصة، والمنطقة العربية عامة.
وقبل التطرق للكتابة عن ربط مصير البشرية بلعبتي: التغير المناخي والفيروسات، بصفتهما الحدثين الأكثر أهمية حاليًا، يهمني جدًا الإشارة إلى أن الصراع العالمي في القطبين: الجنوبي والشمال منذ أكثر من 75 عامًا، قد وصل حاليًا إلى ذروته، وهذا ما سأوضحة لاحقًا مستندًا في ذلك بدراسة خطيرة لكاتبين أمريكيين، وهذا جانب مهم جدًا، والجانب الثاني، الأكثر أهمية - من وجهة نظري المتواضعة - هو الارتكاز على استراتيجية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في استدعاء قواته من أراضي حلفائه دون مبالاة بحماية مصالحهم أو حتى مصالح أمريكا في تلك البلدان، إيذانًا بأهمية وخطورة صراعه مع كلا من: روسيا والصين تحديدًا في المناطق الأكثر استفادة (القطبين الشمالي والجنوبي) بعد التخلى عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط التي باتت – كما نقول في أمثالنا – ورقة محروقة بالنسبة للأمريكان، وربما غيرهم أيضًا....!!
ولأننا ما زلنا تحت رحمة الفيروس اللعين في مرحلته الرابعة من ناحية، وارتفاع درجات الحرارة في بلادنا بشكل غير مسبوق من الناحية الثانية، فمن الطبيعي أيضًا أن نبحث عن كل جديد في كواليس ما يسمى بـ "النظام العالمي الجديد"، وهو – حقيقة – نظام مخيف، ينبئ بكوارث بشرية، لا يتصورها عقل.
ومن يتابع عداء وحقد و..... بني البشر ضد بعضهم البعض لأسباب شيطانية لا تمت للإنسانية بصلة، ثم يتعمق في البحث عن دوافع بعض الدول والمنظمات العالمية للتحكم في المناخ وتخليق الفيروسات لاستخدامهما كسلاح عسكرى وقتما يريدون، يتأكد أن الأمر – جد - ينذر بخطر لا يحمد عقباه، وهذا ما كشف عنه أحد الخبراء العالميين في الأمراض يدعى "دنيس كارول" عندما حذر من أن "الميكروبات القديمة المجمدة تشكل خطرًا على البشرية، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تذيب القطب الشمالي".....!!، ويكرر "كارول" - الذي ظهر في فيلم وثائقي عرض على شبكة "نيتفليكس"، لصحيفة "ميترو" اللندنية – قوله:
- "يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن التقليل من التهديدات المحتملة، والتي يمكن أن تشكلها الجراثيم التي ولدت من جديد، فالأمراض القادمة من الحياة البرية؛ يجب أن تكون مصدر قلق عالمي بعد جائحة فيروس كورونا"......!!
اللافت للنظر للمهتمين بهذه القضايا، أن كلام "كارل" تزامن مع بحث جديد مشابه لعلماء وخبراء عن الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها درجات الحرارة المرتفعة إلى زوبان الكتلة القطبية دائمة التجمد، ومن ثم، تبعث الحياة الجديدة للميكروبات الخاملة كالبكتيريا والفيروسات المتجمدة منذ آلاف السنين، والتي يمكن أن تشمل أمراضًا "قضت عليها البشرية" سابقًا، وهي أمراض لم نواجها أبدًا في عصرنا الحديث.....!!، وهذا ما أفزع "كارول"، وجعله يناشد عقلاء العالم وزعمائه قائلًا:
- "العالم يواجه تهديداً حقيقيًا للغاية في حال دبت الحياة من جديد في تلك الميكروبات القديمة التي ظلت نائمة لحقب طويلة تحت الطبقات المتجمدة، مع تغير المناخ وذوبان الجليد في القطب الشمالي، فالمخاطر التي قد تشكلها هذه الميكروبات التي ولدت من جديد على البشرية غير معروفة، وتأتي جائحة كورونا لتذكيرنا بأننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن التقليل من شأن التهديدات المحتملة للجنس البشري، واسترسل:
-"لذا أنصح بأخذ المخاطر التي قد يشكلها هؤلاء الزائرون القدماء على البشرية بجدية"، وهذا ما أكده أيضًا عدد من خبراء وعلماء وباحثين علي مستوى العالم عندما قالوا أن "متوسط درجات الحرارة في القطب الشمالي قد ارتفع بشكل كبير جدا في السنوات الثلاثين الماضية، ويتوقع أن يستمر في الارتفاع بسرعة أكبر من بقية العالم، مع تفاقم أزمة المناخ"، وفي وقت سابق قام أكاديميون "بتنشيط" بكتيريا عمرها 8 ملايين عام كانت متجمدة، ما يوضح مدى خطورة عودة البكتيريا إلى الحياة.
كما كشفت الأبحاث أيضًا عن آثار فيروسات عملاقة جديدة في التربة دائمة التجمد بالقطب الشمالي، بينما ارتبط ذوبان الجليد في نفس القطب بفيروس "فوسمين" المنتشر من الأطلسي إلى المحيط الهادئ في الفقمة وثعالب البحر، هذا التوضيح يتطابق أيضا مع ما نشره علماء من الولايات المتحدة وأوروبا عن نتائج "المخاطر المستقبلية المحتملة للعوامل المعدية الضارة الناشئة عن إذابة الجليد المتجمد في منطقة القطب الشمالي، إذ يمكن الآن إثبات أن المنطقة القطبية الشمالية أصبحت ذات صلة بها بشكل متزايد بسبب تأثرها السريع بالاحترار والتنمية، وخطر ذوبانها قائم مستقبلاً".
هذا الكلام يؤكد لنا أن ظاهرة تغير المناخ تحمل تهديدات حقيقية لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا؛ بوصفها المنطقة الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك لامتياز أغلب بلدانها بمناخ صحراوي حار، وزيادة معدلات الرطوبة فيها لوقوعها على سواحل الخليج والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب.
ولربط السابق باللاحق، علينا الرجوع إلى ما أعلنته الأمم المتحدة عندما صرحت بأن "العقد الفائت، هو العقد الأشد حرارة في التاريخ، وأن عام 2019، الذي شهد العديد من الكوارث الطبيعية، يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، تبعه ذوبان للجليد، وارتفاع قياسي لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية".
وبطبيعة الحال، حصلت دول الشرق الأوسط على نصيبها من درجات الحرارة القصوى، وشهدت عدة دول في المنطقة موجات حارة غير مسبوقة، كتلك التي أودت بحياة 60 شخصاً في مصر عام 2015، وتشير دراسة أجرتها الجمعية الملكية للأرصاد الجوية إلى أن سكان المدن هم الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة؛ وذلك بسبب ما يعرف بتأثير الجزر الحرارية الحضرية؛ إذ يؤدي نقص الغطاء النباتي في المدن، والحرارة التي تخزنها المباني إلى ارتفاع درجات الحرارة بها عما يحيط بها من مناطق.
هذا الكلام يجرنا جرًا إلى آخر التطورات العسكرية العالمية للسيطرة على القطب الشمالي وقارة أنتاركتيكا في دراسة مهمة لكاتبان أمريكيان: ريان بورك وجهارا ماتيسك، تحت عنوان "الصراع القادم"، يطرح الكاتبان فيه سؤلا مهما: هل تتجه واشنطن لمنافسة بكين وموسكو بالقطب الشمالي؟، ويجيبًا:
- "اكتسبت المناطق القطبية (القطب الشمالي وأنتاركتيكا) أهمية كبيرة بفضل التغيرات المناخية التي جعلتها ساحة للتنافس الدولي بين القوى الكبرى، نظرًا لما تحتويه من مصادر للتعدين والطاقة كالنفط والغاز الطبيعي، كما أنها ستكون بمثابة ممر جديد أمام النقل البحري لجميع دول العالم"، وأضافا:
-"وفي هذا الإطار، سعت كل من الصين وروسيا للاستفادة من المناطق القطبية، بوضع استراتيجيات أحادية وأخرى تعاونية، فضلًا عن تطوير علاقاتهما بالدول المحيطة بالقطب الشمالي. ناهيك عن قيامهما بإطلاق عدد من التجارب للبحث والتنقيب في القطب الشمالي والجنوبي، بينما تنشغل الولايات المتحدة بمصالحها في آسيا وأوروبا على حساب المناطق القطبية (القطب الشمالي وأنتاركتيكا) والتي سيطرت عليها الطموحات التوسعية لكل من بكين وموسكو، لأنها ستكون البوابة الرئيسية للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
انطلاقًا من هذا التوقع، استعرض الكاتبان في دراستهما المعنونة "المحور القطبي الأمريكي: السعي لميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى"، أهم الإجراءات والاستراتيجيات الواجب على الولايات المتحدة اتخاذها لتأمين مصالحها في المناطق القطبية، وذلك بإنشاء "محور قطبي أمريكي" يعتمد بشكل أساسي على استغلال القدرات العسكرية الأمريكية، مع ضرورة بناء شبكة من التحالفات القوية مع دول الجوار الجغرافي المباشر للقطب الشمالي، لردع ومواجهة الخطط التوسعية للصين وروسيا".
وحتما ستؤدّي التبدلات الحاصلة في القطب الشماليّ إلى تغييرات جيوستراتيجيّة جذرية في العالم، عبر تقديم ممرّ بحري جديد لم يكن قائمًا، وبالتالي سيؤثّر على أهمّ الممرّات المائية العالمية وهي قناة السويس، لذا ننبه قيادتنا السياسية، وهي بالتأكيد منتبهة لهذا التطور العالمي الرهيب، بحيث نبحث عن أفضل الطرق والسبل التي تحافظ على أهمية قناة السويس حتى لا يتلاشى دورها الحصري لها العالمي منذ إنشائها، والذي كان وما زال حتى اللحظة سببًا لصراعات وحروب عالمية، ومكانًا للتنافس على النفوذ والسيطرة للدول الكبرى، ولا ننسى أبدا أن لقد شبكة العلاقات الدولية قد تغيرت بشكل ملحوظ من خلال قناة السويس، والخوف كل الخوف من أن تتغيّر مرة أخرى من خلال الممرّات البحرية القطبية التى يشقّها الارتفاع المطّرد في حرارة الأرض......!!
وبمناسبة التطرق إلى الإرتفاع الجنوني المصطنع لارتفاع درجة حرارة الأرض على مناطق بعينها دون سواها، فلا يفوتنا لفت الانتباه إلى أنه على مدار عقود، ركزت المؤسسة العسكرية الأمريكية على توظيف المعرفة العلمية في تطوير أسلحة غير تقليدية لتعزيز تفوقها العسكري، والحفاظ على صدارتها العسكرية، وخلال الفترة التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية، وبداية الحرب الباردة، تصاعد استخدام مصطلح "العلوم العسكرية" تعبيراً عن هذا التوظيف المتصاعد للعلوم الطبيعية من جانب وزارة الدفاع الأمريكية لخدمة غايات عسكرية في مقدمتها مواجهة التهديدات السوفيتية.
وتعد علوم المناخ والمجال الجوي ضمن هذه العلوم التي ركزت عليها المؤسسة العسكرية الأمريكية، حيث قامت القوات الجوية الأمريكية بتمويل مشروعات بحثية لدراسة التحكم في المناخ، وتحويله لسلاح يستهدف أعدائها، وفي هذا الإطار تركز دراسة أحد خبراء المناخ ويدعى ريبيكا بينكوس - المحاضر بأكاديمية حرس السواحل الأمريكية - على تطور "التحكم في المناخ وتسليحه من جانب وزارة الدفاع الأمريكية" خاصة خلال الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مروراً بحرب فيتنام وتداعيات ذلك على طبيعة المواجهات العسكرية المستقبلية بين الولايات المتحدة وأعدائها، وقد تم نشر هذه الدراسة في دورية "الحرب والمجتمع".
لذا فقد اهتم الجيش الأمريكي بدراسة التغير المناخي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف التحكم في المناخ من خلال السلاح الجوي، ولم تكن المحاولات الأمريكية هى الأولى من نوعها في هذا الصدد؛ حيث اتجه الجيش الأمريكي إلى إنشاء نظام لدراسة الأرصاد الجوية منذ عام 1946، كما حدثت بعض التجارب للتحكم في الأمطار .
وعلى الرغم من عدم نجاح هذه التجارب، إلا أنها كشفت عن بعض النتائج الهامة منها أن الثلج وبعض المواد المستخلصة من معدن الفضة من الممكن أن يؤدي للتحكم في كمية الأمطار، ومع حلول عام 1951 تم إنشاء مشروع "سيروس الجديد للتحكم في المناخ" بغرض التحكم في الأعاصير بالإعتماد على بعض المواد الكيمائية على سطح المحيط، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وأدت إلى نشوب حرائق كبرى وتلوث البيئة البحرية.
وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور يهتم بقضية التحكم في المناخ بشكل خاص، وقام بتعيين "هارولد أورفي" كمستشار خاص بالطقس لخبرته الكبيرة في هذا المجال، وقام "أورفيل" بمحاولة ترسيخ فكرة أن هناك "سباق مناخ بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولم يكتف أورفيل بنشر هذه الفكرة في أوساط النخبة الحاكمة بل حاول نشرها بين العامة من خلال تدوالها في الصحف.
ومع حلول عام 1974 عاد الاهتمام مجدداً بموضوع التحكم في المناخ، حيث تأخر إطلاق المركبات الفضائية لتجنب تأثيرات البرق والصواعق، كما بحث العلماء إمكانية استخدام الاستمطار الصناعي في استصلاح الأراضي وزراعة المناطق الصحراوية بهدف التحكم في انتشار التكتلات البشرية في الأقاليم الأقل جذباً للسكان.
كما أشارت تسريبات البنتاجون عام 1971 إلى أن الولايات المتحدة حاولت استخدام المناخ كسلاح خلال حرب فيتنام، حيث تم إبلاغ عدد قليل من الأشخاص بهذا البرنامج وهم: الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العاملة داخل الدولة.
وتذكر التسريبات أن الولايات المتحدة استخدمت الاستمطار الصناعي في جنوب فيتنام عام 1963 لتفريق احتجاجات الرهبان البوذيين، وقد دفعت هذه التسريبات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وعلى رأسهم السيناتور "كليبورن بيل" للمطالبة بوضع معاهدة دولية لحظر التعديل المناخي والبيئي خلال الحروب.
وخلال جلسات الاستماع التي عقدت حول هذه القضية أشار عدد من القادة العسكريين إلى أن الولايات المتحدة قامت بإنشاء برنامج يهدف إلى زيادة الرطوبة والأمطار في مجموعة من المناطق بجنوب شرق آسيا لأغراض سلمية، وبلغت تكلفة هذا البرنامج ما يقدر بحوالي 3,6 مليون دولار سنوياً، وتوقفت العملية في 1 نوفمبر 1968، ودار جدال شديد حول ما إذا كانت الولايات المتحدة استخدمت المناخ لغرض سلمي أم حربي؟
ولحسم الجدل حول هذا الأمر أصدرت الولايات المتحدة مذكرة في 2 مايو 1972 تؤكد أنه سيتم إجراء تجارب لتعديل المناخ لأغراض علمية فقط، وستجري هذه التجارب تحت إشراف مجلس الأمن القومي الأمريكي.
رداً على التحركات الأمريكية المتسارعة في مجال التعديل المناخي قدم الاتحاد السوفيتي مشروع اتفاقية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحظر استخدام التعديل المناخي والبيئي لأغراض عدائية وذلك في عام 1974.
وفتح باب التوقيع على اتفاقية "حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخري "في مايو 1977، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر 1978، وتنص الاتفاقية على أن تكنولوجيا التعديل البيئي (Environmental Modification Technology) لا يجب أن تستخدم في أي أغراض عسكرية أو عدائية لانها تؤدي إلى إلحاق الضرر الشديد بالحياة البشرية، والموارد الطبيعية والاقتصادية على المدي البعيد.
وهو ما يعني أن اتفاقية انمود لم تحظر التعديل البيئي لأغراض عسكرية مادامت تأثيراته محدودة، وفسرت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية على أنها تعني حظر التعديل البيئي الذي يشمل مناطق على بعد مئات من الكليو مترات، وبعيدة المدي أي أن تأثيراتها مستمرة لمدة عدة أشهر، وتنطوي على اضطراب كبير أو إلحاق الضرر بالحياة البشرية، والموارد الطبيعية والاقتصادية، كما فسرتها على أنها تسمح للولايات المتحدة بتلقي طلبات للمساعدة في عمليات تعديل الأحوال الجوية من دول أخري أو منظمات دولية، وهو ما دفع الولايات المتحدة للاستمرار في بحوث التحكم في المناخ والظواهر الطبيعية المرتبطة به مثل الأمطار والسحب، والأعاصير.
ونتيجة لكل ذلك، تابعنا التزايد الملحوظ بالاهتمام بعملية التعديل المناخي في الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض سلمية منذ بداية التسعينيات، فتم السعي لإيجاد آلية تهدف لحماية المواطنين الأمريكيين من التغيرات المناخية القاسية بالتعاون بين مجموعة من العلماء والقوات الجوية الأمريكية، وهو ما عبر عنه مؤتمر (Battlefield Atmospherics conference) المنعقد في عام 1991 في تكساس بالولايات المتحدة تم مناقشة استخدام التقنيات الفيزيائية في إنتاج السحاب الذي سينتج بدوره أمطار ستساهم في زيادة المحاصيل الزراعية.
وفي عام 1996 قام الرائد "باري كوبل" من سلاح القوات الجوية الأمريكية بإعداد تقرير أشار فيه إلى أن التعديل المناخي سلاح يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في أوقات السلم والحرب أيضاً، وأشار أن روسيا قد طورت عدة تجارب في هذا الصدد، وتنفق الصين ما يقدر بحوالي 100 مليون دولار سنوياً للتحكم في الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، كما أنها تمتلك ما يزيد عن 1500 باحث متخصص في مجال التعديل المناخي.
وتزايد هذا الاهتمام أيضا بعد إعصار كاترينا في عام 2005 إذ تم البحث عن آليات تهدف للتحكم في المناخ، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الكونجرس ليتم بعدها وضع قانون ينص على ضرورة إنشاء استراتيجية شاملة لبحوث تعديل المناخ، وبرنامج وطني لبحث وتطوير تعديل المناخ للأغراض السلمية.
ومن المرجح أن يستمر الاهتمام العسكري بدراسات التحكم في المناخ سواء لتنفيذ مهام سلمية أو عسكرية، خاصة في ظل تخصيص الصين وروسيا لموارد مالية ضخمة لتطوير آليات وأدوات غير تقليدية للتحكم في المناخ والظواهر الطبيعية المرتبطة به مما يعزز من احتمالية تفجر سباق بين القوى الكبرى في النظام الدولي لتسليح المناخ.
في هذا الاطار، توضح خبيرة الطاقة الروسية jannamarat@km.ru" أن "الحرب الباردة على القطب الجنوبي وثرواته الكامنة بدأت منذ أكثر من نصف قرن مع اندلاع الحرب الباردة بين القطبين، ففي عام 1947 تعرضت بعثة أميركية في القطب الجنوبي بقيادة الأميرال ريتشارد بورد، ضمت عشر سفن حربية على رأسها حاملة طائرات، إلى هجوم شنته آلات غريبة تشبه الأطباق الطائرة، منطلقة من تحت سطح الماء، وتمكن المهاجمون من إغراق سفينتين أميركيتين وإسقاط طائرة، فتسبب ذلم في فرار الأميركيون من المكان"، وتضيف:
-"وكان رجال المخابرات السوفيتية هم الذين تصدوا «للغزاة الأميركان» هناك وفق ما أعلنه أحد الباحثين القدامى الروس الذين شاركوا في البعثات الاستكشافية التي كان الاتحاد السوفيتي يرسلها إلى منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك عندما اعتقدوا أن من هاجم القوات الأمريكية هي أطباق طائرة لسكان جوف الأرض، وهناك من قال أنها أسلحة متطورة تخص اليابانيين، انطلقت من قاعدتهم العسكرية بهذا المكان".
وما بين هذه التكهنات وتلك الحقيقة، زادت الأطماع في التواجد العسكري والبحثي في القطب الجنوبي، وسرعان ما تم إنشاء العديد من المحطات العلمية والعسكرية التابعة لهذه الدول مثل: بريطانيا، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، واليابان، والأرجنتين، وشيلي، وجنوب أفريقيا.
ورغم أن الاتفاقية الدولية عام 1949 والتي تسري لمدة مئة عام حسب نصها، حرمت أي عمليات تنقيب أو استكشاف لثروات هذه القارة القطبية، إلا أن البعثات القادمة من هذه الدول جميعها بلا استثناء تمارس عمليات التنقيب عن الثروات أكثر من ممارستها للبحث العلمي هناك، والدليل على ذلك إعلان اليابانيين عن وجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي في قاع المحيط المتجمد الجنوبي، ولا شك أنه سيأتي اليوم – وأظنه قد اقترب - الذي يندلع فيه الصراع على ثروات هذه القارة القطبية الجنوبية كما بدأت بوادر هذا الصراع حول القارة القطبية الشمالية تظهر وتتصاعد في السنوات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة وكندا وغيرها من دول الشمال.
ومن الجدير بالذكر أنّ الدول الكبرى لا تعرف شيئًا اسمه التعايش السلمي، ولا تعترف بشيء اسمه المبادىء السياسية، إلّا إذا تحقّقت أطماعها الاقتصاديّة، فالدول الكبرى تحاربت في ما بينها، وكانت رحى معظم حروبها في منطقتنا لما تتمتّع به من ثروات طبيعية وأهميّة استراتيجيّة، جاء الآن، وربّما بنعمة إلهية، أن تتكوّن منطقة أخرى من عالمنا تتقاسم الخصائص والميّزات نفسها، أليس من المفروض علينا، نحن سكان هذا الشرق، أن نستفيد من انشغال الدول الكبرى في تنافس ربما يكون عسكريًا لنبني اقتصاداتنا ونثقل مجتمعاتنا......؟!
كما إنّ حروبًا عالميّة تدقّ طبولها، نسمع صداها وليست في منطقة الشرق الأوسط، منطقتنا الآن مهمة صحيح، ولكنّها لم تعد الأهم في استراتيجيّات الدول العظمى ـ ستصبح المنطقة حديقة خلفية للصراع العالمي وليست ساحته الرئيسة، وستتراجع أهميّة الموقع والطاقة وتصبح الأولوية لمكافحة الإرهاب، المصالح تحكم علاقات الدول وليس العواطف، وستتغيّر الخرائط والتحالفات، وهنا يكمن السرّ، فأين نحن من هذه التغييرات الجذرية المقبلة....؟!.. مصادر محلية وعالمية.. جزء آخر من مؤلفي "وقود الحرب العالمية الثالثة".




 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي