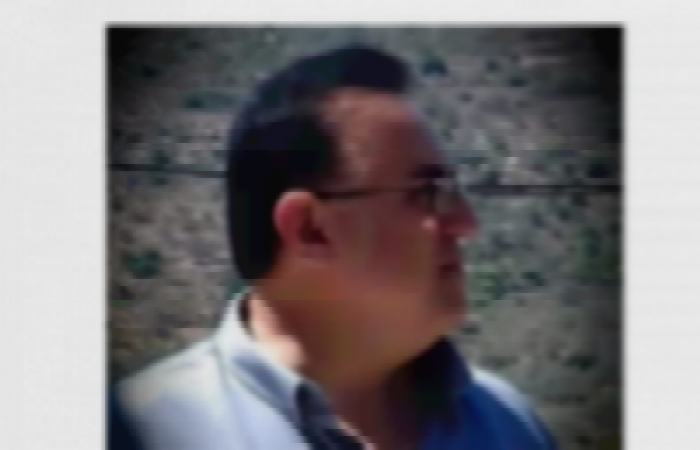رجلٌ عرفَته طفولتي، وكأنّه آتٍ من عصر بعيد في بئر الزمن، أو كأنّ الموت نسيه، نحيل الجسد مع انحناء بسيط في الظهر، وارتجافٍ هادئ للرأس، مع عدم توازن في الوقوف وفي المشي، ذو لحية كثيفةٍ وشعر منكوش ،غطّاهما العمر بثلوج التعب والتعاسة وتحرّرا من قيود الغسل والحلاقة والقصّ،عيناه منقوشتان بلون الإرهاق الأحمر، صغيرتان تنامان في كهفي جمجمته العميقين، فلا غطاء لوجهه إلّا الجلد الذهبيّ الذي يُعادي المياه ماخلا أمطار الشتاء ودموع المزاريب ومياه النهر الذي كان يعبر مجراه كلّ يوم ذهاباً وإياباً...
وقد نجح معلّم الرسم في مدرستنا في رسم وجهه وقسماته التي توحي بالكثير، ولوّنه بالألوان الزيتيّة،وعرض اللوحة في المعرض المدرسيّ غير مرّة، إنّه مجنون الوادي كما لقّبه عارفوه في قريته والقرى المحيطة بالمدينة الصغيرة التي يحتضنها الوادي ،و التي كان يقصدها يوميّاً، قاطعاً إليها ثلاث قرى، بين الأحراج والغابات وواديين سحيقين وجبلاً شاهقاً،كنت ألتقيه دائماً، وأشفق عليه ،وأتقصّدُ أن أمشي متمهّلاً وراءه، أراقب تصرفاته الغريبة، وهو يمشي شارداً بلا توازن لجسده المتعب بين يمين الدرب ويساره، شبه حافي القدمين الذين يغطّي جزءاً منهما أشلاء حذاء ، ويتمتم بكلماتٍ مبهمة بصوت مسموع بينه وبين ذاته، وينحني كثيراً على جانبي الشارع ليلتقط مايعثر عليه من أعقاب لفافات التبغ أو قصاصات الورق أو رؤوس الأعشاب، وأشياء مهملة.....
كنت أحييه بصوتي المرتفع، فيردّ تحيّتي دون أن يهتمّ بالنظر إلى وجهي وأنا أحمل حقيبة المدرسة، ويطلب متألماً منّي ومن المارّة دواءً لرأسه المتوجّع دائماً، وكم كنت أحلم بأن أجد له حبّة علاج تريحه من أوصابه!....
كان عند وصوله المدينة يدخل المقهى الشعبيّ اليتيم الراقد بين أحضان شجر الجوز،والمغشّى بالقصب والقشّ، ويتّجه للجلوس دائماً على كرسيّ الخيزرانّ بجانب الطاولة الخشبيّة المستطيلة، والتي أتعبها الزمن، فتستّرت بغطاء بلاستيكيّ متدلٍّ على جوانبها، يحفظه من الطيران بفعل الهواء خيطٌ مطّاطيٌ، التفّ حول أرجلها، وقد تعوّد صاحب المقهى الطيّب الذي فتح الله عليه أبواب الرزق على ضيفه المجنون ،فكان يرحّب به ويسارع بوضع كأس المتّة والسكّر وإبريق الماء المغليّ الألمنيوم ،الذي يرتدي الوشاح الأسودله ،ويعتبر أن ذلك حسنة ينال جزاءها من مقسّم الأرزاق، فهذا المسكين لايؤذي احداً ،ولايتسوّل، ولايقبل بأخذ أيّة قطعة نقديّة من المحسنين، ولا يلتفت إلى لاعبي طاولة النرد(الزهر) ولاعبي (الشدّة) الورق، ولايكترث بأحاديث المثرثرين من حوله، وقد أصبح ركناً ثابتاً من أركان هذا المقهى المتواضع صيفاً وشتاءً، وكان الكثيرون من روّاد المقهى يتثاقلون عليه بفضولهم وأسئلتهم المحرجة، ويدفعهم إلى ذلك وقاره وشكله الغريب وأمانته وزهده ،فهو لايطلب شيئاً إلا المتة ليحتسي منقوعها الأخضر بكوب زجاجيّ صغير ، وكان يردّ على أسئلتهم بكلمات مختصرة تحمل في طيّاتها الذكاء والحكمة وتثير في أذهانهم الاستغراب من التناقض بين شكله وجنونه وتعاسته، وبين جمله المنتقاة بعناية حكيمٍ متّزن، وأذكرُ بأنّ أحداً سأله مرّةً لماذا لايشرب(العرق)الخمر، فلم يردّ عليه مباشرةً واكتفى بتحريك رأسه المرتجف، ثمّ ألحّ عليه بالسؤال أكثر من مرّة، فما كان من مجنون الوادي إلّا أن أجابه ممتعضاًوأجاب من يتحلّق حول طاولته الصابرة:((أنتم تشربون الخمر هرباً من معاناتكم لتصبحوا مثلي، أمّا أنا فما حاجتي به وأنا على هذه الحال؟!!))........
وبعد انشغالي في وظيفتي ودراستي الجامعيّة وخدمتي للعلم سألت عن مجنون الوادي، فقيل لي وافته المنية رحمه الله ،منذ عقد من الزمن، ولم يكن في جنازته إلّا بضعة أشخاص هم أقلّ عدداً ممّن كان يتحلّق حول طاولته فى المقهى، وارتاح جسده النحيل المتعب، ورأسه المرتجف، وقدماه الحافيتان، ولحيته البيضاء، وشعره الثلجيّ، وحمرة عينيه ، وكلماته الحكيمة، في حفرةٍ تحت شجرة سنديان أغصانها لاتتوقّف عن ذرف أوراقها الصفراء فوق حجارتها وترابها الخشن.....
ومازال المقهى الكريم بكرسيّه الخيزران وطاولته الخشبية العجوز الحزينة، وكأس المتّة وعلبة السكر البلاستيكيّة وإبريق الماء الساخن، وصاحب المقهى الطيّب،وأشجار الجوز، ينتظرون زائرهم المفقود ....
ينتظرون مجنون الوادي.....
ومازلت أحلم بحبّة دواء يبتكرها الطبّ، أهديها له ليرتاح من آلام رأسه.




 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي