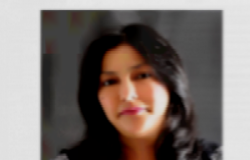في محطة البحوث وبإحدي عربات المترو، تسمرت عيناي باتجاه الباب المقابل لمكان جلوسي وكان مرتكناً إليه شخص أنا أعرفه وأحفظ تماماً ملامحه، وكيف لي أن أجهله وهو رجل من كبار رجالات الدولة، فضلاً عن كونه علماً مألوف الوجه لدي العامة ومعروف تماماً للخاصة، ليس فقط في مصر وحدها أو علي صعيد محيطها، بل والمنطقة بأسرها بملوكها وأمرائها، وزعمائها ورؤسائها؟!
قفزت من مقعدي علي الفور ..
توجهت إليه فسلمت عليه وطلبت إليه أن يجلس مكاني فأومأ برأسه ممتناً وقال " شكراً خليك مرتاح أنا نازل قريب".. قالها بنبرة رصينة هادئة ولم يزد حرفاً بعدها، فلم أكرر العرض عليه، وانتحيت جانباً ولم أعد إلي المقعد الذي بقي شاغراً لثوان ثم أتي أحد الركاب وجلس دون أن يسألني إن كنت سأعاود الجلوس أم لا، وأنا بدوري لم أكترث"علي غير العادة" فقد كانت المفاجأة كفيلة بإلهائي عن الإلتفات إلي من جلس أوكيف جلس!
أتت محطة السادات فنزل الرجل بهدوووء وأكملت أنا الرحلة واقفاً علي الرغم من خلو المقاعد تباعاً بفعل توالي المحطات واقتراب القطار من الوصول إلي محطته النهائية!
ذهبت لمنزل والدي وقصصت عليه ما جري ولكنه لم يصدق!
يعلم الوالد أن ابنه لا يكذب أبداً ولكنه لم يصدق! يعلم أن له ذاكرة بصرية قوية، تحفظ الوجوه وتحتفظ بالملامح ولكنه أيضاً لم يصدقه! ومن ذا الذي بإمكانه أن يصدق أن الدكتور أسامه الباز، عميد الدبلوماسية المصرية، الرجل الذي عمل مع السادات وتعلم منه، وكان هو المعلم الأول لمبارك قبل أن يصبح رئيساً، والذي عمل معه بعدها كمستشار سياسي لثلاثة عقود من الممكن أن يركب المترو أو أن يستخدمه في تنقلاته بشكل اعتيادي كأي مواطن عادي؟!
قال لي والدي حينها ...
بقي مستشار رئيس الجمهورية هيركب مواصلات عامة وهيقف هو والحرس بتوعه في الزحمة وسط الناس؟ إزاي بس؟!
وكانت دهشته واضحة عندما أخبرته بأنني لم أري معه حرس، وأنه قد خرج من المترو بمفرده في محطة التحرير فقال، يبقي أكيد كان واحد شبهه وانت اللي اختلط عليك الأمر!
لم أطل كثيراً في مجادلة الوالد تأدباً، وأغلقنا الموضوع عند هذا الحد .
حدث هذا قبل ما يربو علي خمسة عشر عاماً كاملة، قرأت خلالها كثيراً عن تواضع الرجل ونقاؤه، ترفعه وبساطته وصفاؤه، محبته للفنون، والكثير من صفاته، سجاياه الحميدة وخصائصه العديدة، ثقافته المتفردة وشخصيته الفريدة .
هكذا عاش الباز، الإنسان والسياسي والمثقف والأستاذ .
حفظ الله بلدنا، ونصر زعيمنا وأعاننا .




 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي