تأثر الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي بعدة حروب متتالية ، توالت على مصر بهزائم عدة ، فكتب هاتان المسرحيتان ليدمج الماضى متمثل فى قصة الحسين و يزيد مع الحاضر الذي تعصره و تنكسه الهزائم فى فترة ما حدث بها داخلياً بعض التخبط بين اليمين و اليسار المصري.
كتب عبد الرحمن الشرقاوي مسرحيته «ثأر الله» بجزأيها: الأول «الحسين ثائرًا»، والثاني «الحسين شهيدًا» ما بين عامي ١٩٦٤ و ١٩٦٩ والمسرحية قطعة من التاريخ الإسلامي تمثل مقتل الحسين بن علي وآل بيته في كربلاء، بكل ما تحمل هذه الفترة من أحداث وتفاصيل تاريخية. ولقد اعتمد الشرقاوي في مسرحيته اعتمادً تاريخيًّا حرفيًّا على كتاب «تاريخ الطبري»، إلا من منظرها الأخير، فهو من خياله.
تقدم مسرحية «الحسين ثائراً». وجهاً للعلاقة بين الدين والقيادة في المجتمع الإسلامي. المسرحية تتمحور حول قصة تمرد الإمام الحسين ضد الخليفة الأموي يزيد، أنها ليست سرد تاريخي ولكن أيضًا تعليق قوي على الاعتبارات الأخلاقية التي يجب أن تحكم اختيار الحاكم. من خلال عدسة هذا العمل المسرحي، يمكننا تحليل كيف أن المبادئ الدينية، وخاصة العدالة والتقوى والتشاور، هي عوامل حاسمة في تحديد القيادة المشروعة، وكيف يمكن أن يؤدي غيابها إلى اضطرابات مجتمعية وانحلال أخلاقي.
إحدى المشاكل المركزية التي تم تسليط الضوء عليها في المسرحية هي التجاهل الصارخ للعدالة والحكم الأخلاقي في ظل حكم يزيد. إن صعود يزيد إلى الخلافة، الذي تحقق من خلال الميراث بدلاً من التشاور مع المجتمع، يتعارض بشكل مباشر مع المبدأ الإسلامي للشورى . وهذا المبدأ، الذي كثيرا ما يستشهد به في القرآن (مثل سورة الشورى ، التي تذكر المؤمنين "وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨ ".
يؤكد أهمية اتخاذ القرارات الجماعية ومشاركة المجتمع في اختيار قادتهم. يصور الشرقاوي بمهارة السخط الذي يغلي بين الناس، الذين يشعرون بالحرمان والأعباء من طغيان يزيد المتصور. يتردد صدى هذا مع الواقع التاريخي ويعكس حجة دينية أعمق: أن القائد الذي يفشل في دعم العدالة ويتجاهل صوت الشعب يفقد شرعيته. كما يعلن الإمام الحسين نفسه في المسرحية، «الحاكم الذي يضطهد شعبه لا يستحق الاحترام» .
ركزت المسرحية في عدة مواضع من حيث توظيف التراث والتاريخ الإسلامي؛ فعلى سبيل المثال حاولت المسرحية أن تعالج فكرة اختيار الحاكم الصالح للدولة الإسلامية، فهل يكون الحسين بن علي أم يزيد بن معاوية؟
رجل ١ :
تُب إلى الله وبايع للحسين.
رجل ٢ :
أم ترى تخذله مثل الحسن؟
أسد :
ما خذلناه عليه رحمة الله،
ولكن ترك الأمر لأهله.
بشر :
أوَلا كان الأمر حقًّا لابن هند،
أم تساوقتم إليه طمعًا فيما لديه؟!
سعيد :
آه منكم يا سراة الناس في هذا الزمن!
أنتم يا مَن تألبتم على حكم علي،
عندما حاسبكم عما اقتنيتم،
عندما رد لبيت المال ما كنزتم،
عندما نازعكم إقطاعكم،
ثمَّ سوَّى بين كل المسلمين!
بشر :
والحسين بن علي عندما يغدو إمامًا،
فسيغدو كأبيه … كأمير المؤمنين؛
فيقيم العدل في الناس ويبغيه سلامًا،
وسيغلو في حساب الأثرياء الكانزين.
سعيد :
إذ يراهم كَفَرة.
بشر :
ولهذا سوف لا يتبعه إلا قليل.
وبعد الحوار السابق بعدة صفحات، تأتي المقارنة بين الحكَّام بصورة حضارية أكثر:
رجل ٤ :
لم يعد يصلح للدولة حكم الخلفاء الراشدين!
رجل ٥ :
نحن في عصر الملوك القادرين.
بشر (ساخرًا) :
والرعايا الطامعين الخائفين.
سعيد :
إنه عصر مشوب بالحنين.
بشر :
بحنين لنبالات الرجال الصادقين الصالحين.
الصراف :
لقد صرنا في زمن آخر.
أسد :
ولكل زمان دولته ورجال أعرف بأموره،
وحسين قرة عين رسول الله يعيش زمانًا قد ولَّى،
ما عاد رجال كعلي لحكومة دولتنا أهلًا.
وحسين يسلك مثل أبيه،
وله مثل صلابته،
فإذا صار ولي الأمر فسوف يسير كسيرته،
والدولة تطلب رجلًا آخر لا كعلي وحسين؛
فليس نجاح ولي الأمر في أن يحكم بضميره،
أو أن يقضي عن نزعته أو تقديره.
نجاح الحاكم أن يستفتي في الأحكام ضمير الأمة.
ومن الملاحظ أن الأقوال السابقة كانت لأصحاب الحسين، وكذلك لعامة الناس. أمَّا آل البيت فهم يؤكِّدون ذلك أيضًا:
زينب (منفجرة) :
يا أخي، اذكر أننا في زمن لا يطلبك.
الحسين :
إنما أطلب للناس الهدى.
زينب :
الرجال اليوم لا يرضون إلا بملك،
لم يَعُد بعدُ مكانٌ لإمام أو خليفة،
أُهدِرت كل التقاليد الشريفة.
إنهم لا ينشدون اليوم إلا حاكمًا يعطي ويمنع،
حاكمًا يعرف ما يبتاع منهم … ثمَّ يدفع!
والشرقاوي أراد من وراء هذه الفكرة — فكرة الحاكم الصالح — أن يقيم صراعًا بين اليمين واليسار، وممثل اليمين يزيد وأتباعه، وممثل اليسار الحسين وأتباعه.
تؤكد المسرحية أيضًا على أهمية التقوى والنزاهة الأخلاقية في القيادة. تم تصوير شخصية يزيد على أنها معيبة أخلاقياً، - وهو كان كذلك ، على الأقل فى رأيي الشخصي - ،وتنغمس في الملذات الدنيوية وتتجاهل التقاليد الدينية. وهذا يتناقض بشكل حاد مع تصوير الإمام الحسين، الذي يجسد التقوى والالتزام الثابت بالقيم الإسلامية. يشير السرد ضمنيًا إلى أن السلوك الشخصي للحاكم يؤثر بعمق على النسيج الأخلاقي للمجتمع. القائد الذي يجسد التقوى بمثابة نموذج يحتذى به، ويلهم السلوك الصالح ويعزز الشعور بالمسؤولية الأخلاقية بين الناس. يتماشى هذا المفهوم مع الفهم الإسلامي للقيادة باعتبارها أمانة (أمانة)، مما يتطلب من القائد العمل وفقًا للتوجيه الإلهي وإعطاء الأولوية لرفاهية المجتمع.
في نهاية المطاف، تقترح «الحسين ثائراً» حلاً لمشكلة الحكم الجائر من خلال فعل المقاومة وإعادة تأكيد المبادئ الدينية التأسيسية. تم تصوير قرار الإمام الحسين بمواجهة يزيد، على الرغم من الصعاب الساحقة، على أنه عمل صالح أخلاقياً تم القيام به لدعم العدالة والدفاع عن الروح الحقيقية للإسلام. إن تضحيته بمثابة تذكير قوي بأن تحدي الحكم القمعي، عندما يتم استنفاد جميع السبل الأخرى، ليس مسموحًا به فحسب، بل هو أيضًا التزام ديني. هذا يتردد صداه مع المفهوم الإسلامي. (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وهو مبدأ أساسي يتطلب من المؤمنين العمل بنشاط من أجل تحسين المجتمع والتحدث علانية ضد الظلم.
* كما أوضح العالم خالد أبو الفضل، "مقاومة الاستبداد ليست مجرد حق ؛ وهو واجب ديني، لا سيما عندما يرتكب ذلك الطغيان باسم الدين نفسه "(أبو الفضل، 2001، ص 12).
في الختام، من خلال تصوير عواقب الحكم الظالم والمقاومة الشجاعة للإمام الحسين، تحض المسرحية بضرورة التمسك بالمبادئ الدينية - العدالة والتقوى والتشاور - في اختيار الحاكم وسلوكه. تعمل المسرحية كتذكير خالد بأن القيادة الشرعية لا تعتمد فقط على السلطة أو الميراث، ولكن على السلطة الأخلاقية المستمدة من الالتزام بالتوجيه الإلهي وخدمة مصالح المجتمع الفضلى. لا تزال الدروس المستخلصة من «الحسين ثائراً» ذات صلة اليوم، حيث تقدم رؤى قيمة حول الاعتبارات الأخلاقية التي يجب أن توجه السعي وراء السلطة وممارستها في أي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة والنزاهة الأخلاقية.
المراجع
Abou El Fadl, K. (2001), Rebellion and Violence in Islamic Law. مطبعة جامعة كامبريدج.


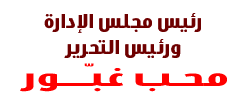
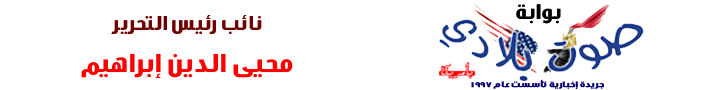
 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي









