ليست هناك دولة تعتمد المعونات أداة رئيسية من أدوات تنفيذ سياستها الخارجية وجزءا لا يتجزأ منها سوى الولايات المتحدة, صحيح هناك دول كبيرة تُقدم بعض المنح أو تتبنى برامج مساعدات فى قطاعات معينة إلا إنها لا ترقى إلى هذا المستوي, والسبب واضح وهو امتلاك وسيلة ضغط على الدول حتى تتماشى سياساتها ــ إن لم تتطابق ــ معها, وهو أسلوب أقرته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهورها كقوة عظمى على الساحة الدولية. بعبارة أخري, إن تقديم واشنطن أى مساعدات لابد أن يرتبط بديهيا بأهداف سياسية واستراتيجية أكبر مما يبدو على السطح وأن شروط تقديمها قابلة دائما للتوسع فيها, سواء كانت شروطا تتعلق بالشئون الداخلية أو الخارجية.
فى هذا السياق يمكن قراءة قرار اقتطاع وتجميد جزء من المعونة المقدمة لمصر, والذى ستظل له تداعياته على مجمل العلاقات المصرية الأمريكية, فالمعروف أن هذه المعونة تقررت بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 (أى لأسباب سياسية بحتة تتعلق بتوجهات السياسة الإقليمية المصرية) وأن لها شقين: عسكرى (1٫3 مليار دولار سنويا) واقتصادى (815 مليون دولار سنويا خُفضت تدريجيا حتى وصلت إلى 250 مليون دولار سنويا) وبالقرار المشار إليه, الذى صدر على خلفية اتهام القاهرة بعدم الالتزام بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة بعد التصديق على القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية, تم إلغاء 95٫7 مليون دولار من الشق الأخير، وتجميد أو تأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية.
والواقع وبرغم الضجة التى صاحبت هذا القرار, فإنه لم يكن الأول من نوعه, فقد سبق لإدارة باراك أوباما السابقة أن علقت المعونات لمدة عامين ومعها بعض صفقات سلاح وأوقفت التدريبات العسكرية المشتركة (النجم الساطع) بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان الذى أيدته, فضلا عن خلافاتها الأخرى مع السياسة المصرية فى الملفات الإقليمية من سوريا إلى ليبيا, وكذلك فعلت قبلها إدارة جورج بوش الابن فى زمن مبارك لنفس الأسباب (المعايير الديمقراطية) إلى جانب قضية أنفاق غزة, أى دائما خليط من الأسباب الداخلية والخارجية.
لكن مصدر الانزعاج هذه المرة, أن قرار تخفيض المعونة أتى فى ظل إدارة دونالد ترامب, الذى تربطه علاقات جيدة بالرئيس عبد الفتاح السيسي, والذى أعلن مرارا أنه لا ينوى التدخل فى شئون الدول وتهميشه لأجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان على عكس من سبقوه, لدرجة أن علق الدبلوماسى والسياسى الأمريكى الشهير مارتن إنديك ساخرا على القرار بقوله إنه أشبه بقرارات أوباما التى طالما انتقدها ترامب.
الحقيقة أن الرئيس الأمريكى مهما بلغت سلطاته وصلاحياته يظل مقيدا بمؤسسات الدولة التى تشاركه صناعة القرار, مهما تمرد عليها (كما فى حالة ترامب) وفق نظام صارم للتوازن بين السلطات, فللكونجرس مثلا سلطات موازية للرئيس, الذى لا يستطيع تعيين معاونيه (وزرائه) وسفرائه للدول الأجنبية إلا بموافقته وله الحق فى استدعائهم والاستماع إلى شهادتهم فى كل الأمور الخاصة بسياسات الدولة فى الداخل والخارج, وكذلك بالنسبة للاعتمادات الخارجية, بل إن حقه فى الاعتراض على القوانين (الفيتو الرئاسي) يتم تجاوزه إذا ما صوت ضده الكونجرس بأغلبية الثلثين مثلما حدث مع أوباما عندما حاول إيقاف إقرار قانون «جاستا» (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذى قيل إنه يستهدف السعودية أهم حليف لأمريكا فى المنطقة.
المتابع لسير الأحداث يلاحظ أن الكونجرس بالذات كانت له مواقف معادية للنظام المصرى طوال الفترة الماضية, وهو الذى طالب أكثر من مرة بجعل المعونة لمصر مشروطة, وقد كتبت فى هذا المكان تحت عنوان «أزمة الكونجرس مع مصر» فى 6 مايو الماضي, عن جلسة الاستماع التى بُنى عليها القرار وكانت لثلاثة من الخبراء والسياسيين والدبلوماسيين السابقين (ميشيل دن, إليوت أبرامز, توم مالينوسكي) الذين أكدوا هذا المطلب خاصة ما يتعلق بالمساعدات العسكرية, باعتبار أن تخفيض المعونات الاقتصادية كان قد تقرر لجميع الدول وفقا لما أعلنه البيت الأبيض, والأخطر من ذلك هو ما أثاروه حول نمط تسليح الجيش المصرى ليتم التركيز فقط على نوع الأسلحة الضرورية لمواجهة العمليات الإرهابية فى سيناء, وبعد ما يقرب من شهر أصدر ثلاثة من أهم النواب الجمهوريين, أى من المنتمين لحزب الرئيس (جون ماكين, ليندسى جراهام, ماركو روبيوـ ومعهم تسعة أعضاء آخرين) بيانا توجهوا به للرئيس يحمل نفس المضمون, ولأن ترامب يعانى من مصاعب وأزمات داخلية عديدة فلم يكن فى وضع يسمح له بتحدى الكونجرس أو حزبه الذى يشكل الأغلبية بداخله, فالأمر لا علاقة له بقناعاته الشخصية.
أما السبب الآخر الذى كشفت عنه الواشنطن بوست فى تقرير مطول لها بعنوان «مصر قد تكون أحدث جبهة فى معركة ترامب مع كوريا الشمالية», والذى أرجعت فيه السبب فى خفض المعونة إلى علاقة مصر ببيونج يانج واستمرار تعاونها معها رغم الحصار المفروض عليها, فهو ينطبق تحديدا على الرئيس الأمريكى, الذى أعلن صراحة أنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الولايات المتحدة ولحلفائها كاليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن أوروبا بل والعالم أجمع ــ على حد تعبيره ــ بسبب تجاربها النووية والصاروخية الباليستية وتصديرها هذا النوع من التسليح, وسبق أن وضعها فى نفس خندق إيران التى يعتبرها مصدر الإرهاب فى العالم, ولا شك أن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الخصوص بطلب أمريكى يعكس مدى الأهمية التى تحتلها هذه القضية لدى واشنطن. لذلك أراد ترامب بقراره الأخير الخاص بمصر أن يضرب عصفورين بحجر واحد, بمعنى أن يحتوى الكونجرس من ناحية ويضغط لتنفيذ أجندته الخاصة بكوريا الشمالية من ناحية أخري.
إن ما يمكن استخلاصه من هذه الأزمة الطارئة فى العلاقات المصرية الأمريكية يشير إلى ضرورة عدم قصر أى رهان سياسى على شخص الرئيس الأمريكي, فالتواصل مع المؤسسات الأخرى لا يقل أهمية عن الرئيس, وأن القضايا الإقليمية والدولية الخلافية يجب أن تُحل من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية وليست وسائل الإعلام المحلية, التى لا تُخاطب إلا نفسها مثلها مثل الكتابات التى طالبت الدوائر المصرية الرسمية بالاستغناء الفورى عن المعونة, لأنها فى النهاية لا تُقاس فقط بقيمتها المادية وإنما هى رمز للعلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن ما لم تقرر مصر خيارا آخر.
أزمة ترامب
كشف حادث مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا, الأمريكية, الذى وقع الأسبوع الماضى, عمق الأزمة الداخلية التى يعانى منها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أو بالأحرى أزمته الرئاسية والتى بدأت تقريبا منذ الأسابيع الأولى على توليه مقاليد السلطة.
الحادث باختصار تمثل فى تنظيم مسيرة حاشدة من المؤيدين للجماعات العنصرية البيضاء من أنصاراليمين المتطرف (النازيون الجدد وكوكلكس كلان) احتجاجا على إزالة تمثال الجنرال روبرت لى أحد أهم القادة العسكريين فى الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) المعروف باتجاهه العنصرى وتأييده العبودية, واشتباكهم على الجهة المقابلة بمتظاهرين مناهضين للتمييز العرقى من ذوى الاتجاهات اليسارية والليبرالية, فى مواجهة اتسمت بالعنف بعد عملية دهس بسيارة قام بها أحد المتطرفين اليمينيين أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.
أى قارئ لتاريخ أمريكا الحديث فى مكافحة العنصرية سيعرف مدى حساسية هذه القضية وخطورتها, وأن هذا الحادث لن يكون سوى بداية لصراع مجتمعى أشمل, فمنذ أحداث «ديترويت» الشهيرة أكبر مدن ولاية ميتشجان فى 1967 وما تلاها من أعمال عنف امتدت لمئات المدن وعشرات الولايات, وهذه القضية سبب رئيسي فى انقسام المجتمع الأمريكى, بل وكانت موضوعا لفيلم سينمائى للمخرجة «كاثرين بيجلو» عُرض منذ أيام حاملا اسم «المدينة» تعبيرا عن الرفض المطلق للممارسات العنصرية, ولكن «ديترويت» لم تكن الأخيرة, فبعدها بعام اغتيل القس مارتن لوثر كينج رائد النضال من أجل الحقوق المدنية للأمريكيين من أصول إفريقية, وطوال العقود الماضية وحتى سنوات الألفية الحالية استمرت مثل هذه الحوادث بصورة متقطعة, وإن سيظل لحادث فيرجينيا خصوصيته لكونه وقع هذه المرة ليس بين الشرطة والمواطنين السود كما كان يحدث فى الماضى, ولكن بين شرائح مختلفة من المجتمع, والأهم من ذلك أنه وقع فى ظل وجود رئيس أمريكى ينتمى لذات التيارات اليمينية ويرفع شعاراتها, وهى سابقة لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل.
لذلك لم يكن غريبا أن تتوالى ردود الفعل الغاضبة من معظم الدوائر الأمريكية على تصريحات ترامب, التى ألقى فيها باللوم على الجانبين تعليقا على الحادث, لم تقتصر على وسائل الاعلام والمثقفين والأكاديميين والمنظمات الحقوقية وإنما على الحزبين الكبيرين الديمقراطى (المعارض)، والجمهورى (الذى جاء الرئيس من بين صفوفه) أى دوائر الحكم, وهو ما دعا البيت الأبيض لاستدراك الأمر بإصدار بيان آخر بلهجة أكثر حسما.
ولنفس السبب تلاحقت استقالات مستشارى الرئيس (ست استقالات أغلبها فور الحادث مباشرة) فى واحدة من أهم اللجان الاستشارية الاقتصادية، شملت كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الصناعية الكبرى, اعتراضا على حالة الاستقطاب السياسى وتأثيرها السلبى على استقرار المجتمع، فضلا عن انتهاك المثل العليا فى المساواة التى قام عليها المجتمع الأمريكى, ما أدى إلى فض اللجنة, ثم جاءت استقالة أو إقالة ــ كما وصفتها النيويورك تايمز ــ ستيف بانون أحد كبار مستشارى ترامب السياسيين ذى التوجه اليمينى كجزء من احتواء الأزمة.
الواقع أن ظاهرة الاستقالات والإقالات باتت سمة رئيسية ملازمة لإدارة ترامب بغض النظر عن حادث فيرجينيا, فقبله وفى غضون فترة قصيرة تمت استقالة أوإقالة المتحدث باسم البيت الأبيض (أنتونى سكاراموتشى) ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى (جيمس كومى) ومستشار الرئيس للأمن القومى (مايكل فلين) وكبير موظفى البيت الأبيض (رينس بريبوس) وغيرهم, ما يعكس خلافات الرئيس المستمرة مع فريقه ومساعديه بصورة تزيد على المعتاد أو المتعارف عليه, ربما بحكم طبيعته الشخصية التى يغلب عليها الانفعال اللحظى ما يجعله يتجاوز بسهولة السياسات المعتمدة رسميا.
وليست هذه مظاهر الأزمة الداخلية الوحيدة, فأغلب قراراته الرئاسية تصطدم بمؤسسات الدولة مثلما حدث بشأن منع مواطنى سبع دول إسلامية من دخول أراضى بلاده, والتى أوقفت تنفيذه المحكمة الفيدرالية بنيويورك واستجاب لها جهاز الأمن الداخلى قبل أن تلحق بها محاكم ولايات أخرى. إضافة إلى ذلك, يخضع ترامب حاليا لتحقيقات قانونية بشأن علاقته وفريق حملته الانتخابية عندما كان مرشحا للرئاسة بروسيا, وتم أخيرا تشكيل لجنة «محلفين عليا» للفصل فى مسألة توجيه تهمة جنائية إليه بهذا الخصوص إلى جانب الكشف عن حساباته البنكية الشخصية للتأكد من عدم تلقيه أموالا من موسكو قبل الانتخابات, بل أكثر من ذلك وُجهت إليه اتهامات فى مايو الماضى, وفق ما نشرته الواشنطن بوست, بإفشاء معلومات سرية لوكالة المخابرات المركزيه إلى وزير خارجية دولة تعُد فى صراع مع الولايات المتحدة فى إشارة أيضا إلى روسيا.
بعبارة واحدة, حادث فيرجينيا ليس سوى فصل جديد من فصول أزمات ترامب فى الرئاسة وصدامه مع مؤسسات الدولة (وزارة الخارجية والعدل والقضاء والمخابرات والمباحث الفيدرالية) وطبيعة المجتمع الأمريكى والثقافة العامة السائدة, لدرجة أن تحدث الأمريكيون عن إمكانية عزله أو استقالته من منصبه, وهذه ليست بالأمور الهينة كون مبدأ عزل الرؤساء لا يُطرح إلا فى أضيق الحدود ولا يتم الاقتراب منه بهذه السرعة أى قبل مضى عام على شغل المنصب كما هى حالة ترامب, وربما أشهر واقعتين معاصرتين كانتا مع بيل كلينتون (1998) على خلفية اتهامه بالكذب فى علاقته بالمتدربة بالبيت الأبيض (مونيكا لوينسكى) إلى أن قدم اعتذارا علنيا, وريتشارد نيكسون (1974) بسبب فضيحة ووترجيت وإن بادر بتقديم استقالته مضطرا.
لا شك أن هذه الأزمة الداخلية تنعكس على مجمل الأداء السياسى للإدارة الحالية خاصة فى مجال السياسة الخارجية, ففى كل الملفات كان التضارب فى التصريحات والتراجع فى المواقف هو العنوان الرئيسى, فى الأزمة السورية والإيرانية والقطرية، وكذلك بالنسبة لروسيا, وأوروبا والعلاقة مع الناتو وفى ملف كوريا الشمالية وحتى المكسيك والجدار العازل الذى أُعلن عن بنائه فى المنطقة الحدودية, وكلها مجرد أمثلة.
الرئيس دونالد ترامب لم يتغير كثيرا عن المرشح دونالد ترامب, قدم نفسه على أنه المتمرد على كل الأطرالمؤسسية التقليدية سواء التنفيذية أو الحزبية، واعتمد ــ ومازال ــ وسائل التواصل الاجتماعى بديلا عن الإعلام, تغريداته على تويتر تسبق سياساته المدروسة مع باقى مؤسسات صناعة القرار, يشعر بأنه مستقل رغم حزبيته الطويلة ولا يدين بنجاحه إلا لأنصاره وأغلبهم من الاتجاه اليمينى أو غير الحزبى, فهل سيكسب رهانه الذى اختاره أم أن قوة المؤسسات هى التى ستفرض نفسها عليه؟ هذا فقط هو السؤال.


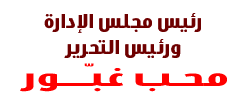
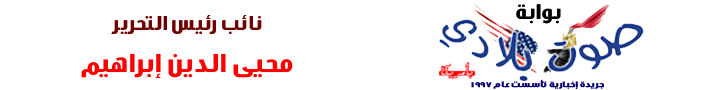
 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي









