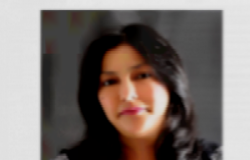لا أُنكر أن “الدكترة” كانت حُلما يراودنى من الصغر-ليس انا فقط- ولكن معظم أبناء جيلى، خاصة في أثناء المرحلة الجامعية.. فقبلها لم يكن أحدنا يعرف ماذا تعنى كلمة “دكتوراه” وكنا حين ندرس سير رجال الدين الذين تخرجوا من مدرسة الأزهر الشريف، كانوا يخبروننا بأن العالم الفلاني حصل على “درجة العالمية” وحين كنا نسأل عن معناها يخبروننا بأنها “درجة الدكتوراة”، ولم نكن نعلم أنه سوف يأتي علينا يوما يصبح فيه العلم مجرد شهادة من ورق.. أو يصبح لدينا أشخاص عاملين بالعلم، وليسوا علماء!
كان لقب دكتور لدينا لا يعطى إلا لخريجى إحدى كليات الطب، دون أن نعرف أن هناك شهادة علمية أسمى هي “الدكتوراه” وحين كنا في مرحلة البكالوريوس لم نكن نعرف سوى طريق واحد للحصول على هذه الدرجة العلمية العظيمة.. هو التفوق في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.. وأن المتفوق الذي يفوته الحظ في التعيين كـ”معيد” بالجامعة يسعى لاستكمال دراساته تأكيدا لإرادته الحرة في الحصول على درجة الدكتوراه والعمل في السلك الجامعى.
ولم نكن حينها نتخيل أنه سوف يأتى علينا يوم نرى فيه الشهادات العلمية العليا تباع في “دكاكين” تحت السلم، كما تباع كنوز مصر من “التراث المعرفى” بجوار “سور الأزبكية” وعلى “الأرصفة” بجوار أسوار الجامعات.. لم نك نتخيل أن لهذه الدرجة العلمية “الرفيعة” أنواع منها الدكتوراه المهنية والدكتوراه الأكاديمية والدكتوراه الفخرية وقريبا جدًا الدكتوراه بالملوخية!
حينها كان لأستاذ الجامعة مكانته الخاصة في المجتمع، لأنهم كانوا بحق قلة فاعلة، تحمل مشاعل “التنوير” إلى قُراها وأحيائها ومُدنها وأوطانها.. حين كان لزامًا على العلم أن يساهم في حل مشكلات المجتمع الذين يعيشون فيه.. فكان للشهادة العلمية وزنها.. ولم تكن كما هو الحال الآن كمالة للوجاهة الاجتماعية أو ديكورًا تُزَيَن به حوائط البيوت، أو مجرد حبر على ورق!
لقد كان حاملو شهادات الدكتوراه بمثابة “فلاسفة” يوقنون أن العلم وجد لخدمة المجتمع، والاتقاء بخصائص أبنائه، والنهوض بمكوناته، وإن لم يكن العلم كذلك فلا حاجة للمجتمعات به.. لم نكن نعلم أيضا أنه سوف يأتى علينا اليوم الذي تُشكك فيه المؤسسات التعليمية في “دول الخليج” في شهاداتنا العلمية، وتدعى بأنه قد تكون شهادتنا العلمية “مضروبة” حتى وصل الحال إلى محاولة الاستغناء عن حاملى شهادات الدكتوراه المصرية، ما عدا الشهادات الموثقة ومن جامعات مصرية بعينها!
حينها كان الأستاذ عالما يعمل بوظيفة معلم.. فينساب العلم من لسانه ويده إلى أبنائه كالنهر، يغرس القيم في وجدانهم، وينبت على أيديهم الشجر، ويُفَجِرُ من تحت أرجلهم الأنهار، ويمد الجسور ويمهد الطرق. أما الآن فقد صار “البحث العلمى” تمثيلية كبيرة، فهذا طالبُ عِلم تقديره لم يتجاوز “المقبول” ولم يحضر إلى الجامعة إلا وقت الامتحان، تعذر عليه بعد التخرج الحصول على وظيفة، فكان لابد أن يشغل وقته الضائع في الالتحاق بالدراسات العليا.
وبدأ العدد يكبر شيئا فشيئا حتى صار طلاب الماجستير والدكتوراه في بعض “الكليات النظرية” يقترب من عدد طلاب البكالوريوس أو الليسانس.. وهنا نتساءل هل ساهمت البطالة في أزمة البحث العلمى وترهل الشهادات العلمية في مصر، أم أن تراجع البحث العلمى ومظهرية الشهادات العلمية هي من تسببت في طوابير البطالة التي تعج بها شوارعنا التي لم تعد منهم آمنة؟!
ومن ثم فإننا أمام كارثة تجرى تحت أقدامنا، دون أن نتحسس فيها مكامن الخطر، وذلك أولًا لأن البحث العلمى خرج عن مساره الصحيح؛ فكما قلت أنفًا أنه يجب على البحث العلمى الذي تدعمه الدولة أن يساهم في حل “مشكلات قائمة” في المجتمع أو يتنبأ بـ”مشكلات قادمة” ويعد سيناريوهات عديدة للتعامل معها، وإذا كان الأمر كذلك فما هذا الكم من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمنح كل عام وتوضع على أرفف المكتبات ويتم “إعدامها” كل خمس سنوات.. وكأننا لم نكن نجرى بحثًا علميًا حقيقيًا وإنما كنا نعمل في “تدوير الورق”!
ثانيًا إن “الاستسهال” في منح شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية جعل الإقبال على هذا التخصصات كثيفًا. بعكس الكليات العلمية، التي يكون الإقبال عليها ضعيفًا، نظرا لحجم “تكلفة البحث” ومشقة الوصول إلى نتائج حقيقية، ومن ثم مشقة الحصول على الشهادة العلمية.. ولهذا فإن معدل البطالة بين حاملى شهادات الماجستير والدكتوراه في العلوم الإنسانية يقترب من معدل البطالة لدى حاملى شهادة البكالوريوس في العلوم العلمية!
ثالثًا لقد ربطت بعض كليات العلوم الإنسانية بين عدد طلاب الدراسات العليا و”تعبئة موارد الكليات” مما جعلهم يفتحون الباب أمام الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا على مصرعيه، دون تمحيصٍ في إجراءات القبول، وتدقيقٍ في موضوع البحث، وحرصٍ على منح الدرجة العلمية لمن يَستَحِق، بالتقدير الذي يُستَحَق.. لدرجة أنه بات من الصعب “التمييز” بين الطلاب حال الإعلان عن وظيفة جامعية شاغرة.. مما يفتح بابا واسعا للفساد، ويجعلنا نتساءل هل سوف يأتى علينا يوم لا تعترف فيه مؤسسات العمل بشهادات البكالوريوس والماجستير، ويصبح فيه الحصول على شهادة الدكتوراه شرطا للعمل فيها؟! وإذا كان الأمر كذلك فما مستقبل حاملى شهادات التعليم الفنى المتوسط وفوق المتوسط؟!
رابعًا أدى تراجع عمليات “الرقابة” في كل القطاعات إلى ظهور مؤسسات “غير شرعية” تمنح شهادت الدكتوراه مقابل مبلغ من المال لا يتجاوز 300 دولار.. وإن عدد الحاصلين على هذه “الشهادات المضروبة” أصبح مخيفا، لدرجة أننى أكاد أبدأ في الشك بمجرد أن أرى حرف “الدال” يسبق أي اسم! والسؤال لماذا لم تتبع الدولة هذه التجارة الفاسدة، وتعمل على إغلاق هذه “الدكاكين” التي تساهم بقوة في إفساد التعليم في مصر؟!
خامسًا أن “القنوات الفضائية” عادة ما تستضيف على شاشاتها أصحاب الشهادات المضروبة، وتقدمهم للجماهير باعتبارهم “دكاترة” ومتخصصين وخبراء، مما يُسَهِّل على هؤلاء الأشخاص عمليات “النصب” باسم العلم. ويقع المواطن البسيط فريسة لهذا “الإعلام غير المسئول” وهنا أيضا أتساءل: هل حان الوقت لأن يتحرى “الإعلام” الصدق والأمانة حين يقدم هؤلاء “النصابين” إلى الجماهير؟!
سادسًا وهو الأخطر أن يتم “تعيين” بعض أصحاب الشهادات العلمية المضروبة في وظائف قيادية عُليا، تبدأ من العمل كأستاذ بإحدى الجامعات حتى رئيس جامعة وكذلك وزير.. فلا نستطيع أن ننسى واقعة الإعلامي توفيق عكاشة، وواقعة رئيس جامعة الأزهر.. والكارثة التي كشفها د. الشوادفى منصور وزير التعليم العالى السابق حين صرح بأن هناك أكثر من 50 شخصا من الوزراء السابقين والمحافظين يحملون شهادات دكتوراه مضروبة”! فأين كانت التحريات؟!
وعمومًا فإننى أتصور أن البحث العلمى في بلادنا قد صار “مريضا” أو بالأدق “تمثيلية كبيرة” فيها طالب يمثل أنه يبحث.. وأستاذ يمثل أنه يُشرِف.. ودولة تمثل أنها تُمول.. وصار لدينا علما من ورق!




 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي